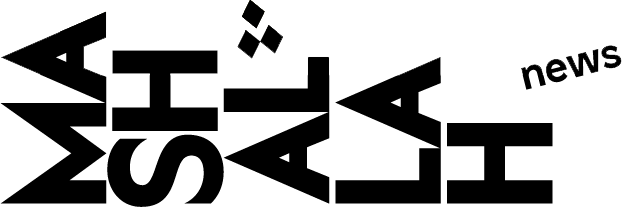ابن الشمس

I.
ثلاثة أسابيع مرّت منذ انفجار مرفأ بيروت وما زلت لا أعرف ماذا أقول.
يسألونني: “هل تشعر بالألم؟”. أسأل نفسي عمّا يقصدونه، ولا أدري ماذا أقول.
تخطر في بالي الإصابة البالغة في قدمي اليسرى والاثنتا عشرة درزة في ذراعي اليمنى والتشنّج في أسفل ظهري. أحاول التعبير عمّا شعرت به عندما اخترق حطام الزجاج وسموم نيترات الأمونيوم جسدي وعظامي، فتخونني الكلمات. أفكّر بالألم الخفيّ المنتشر في جسدي والذي لم أتمكن من تحديده لأنّ الوقت لم يمرّ وما زلت مخدّرًا بالكامل. أفكّر في بيروت وما حدث لها. أفكّر في الصدمة وبما تفعل بنا. أفكّر في الكوابيس التي تتجدّد في كلّ ليلة. أفكّر بالناس في الطريق إلى عيادة الطبيب وما يتراءى لي في أعينهم. أفكّر بالظلم وبثورتنا، فتعود خيبة الأمل. لكنني أفكّر أيضا بالجمال؛ جمال الألم وكيف يُبرز أفضل ما لدينا أحيانًا.
أفكّر في كل ذلك، ثمّ أتلعثم في الكلمات.
هل تشعر بالألم؟
قد أكون غير صادق إن قلت “لا”. لكن كلمة “أجل” تفتح الباب على المجهول. “أجل” تأخذني إلى أماكن لا أرغب بالضرورة اصطحاب من يسألونني إليها. لذلك، أجيب أحيانًا، أو قليلًا. أشرح كيف يأتي الألم تارةً ويذهب تارةً أخرى، وكيف أعتمد على المسكنات. أشرح لهم أن ذلك يكبح مشاعري. أستخدم كلمة “لكن” كثيرًا كي أقول أنّ وضعي يتحسن، أو أنّه كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير. أقول ذلك لأجعل الحديث أقلّ ثقلًا ولأتمكن من سحب نفسي منه بكل لباقة.
هل تشعر بالألم؟
أغلق عينيك. ماذا ترى؟ بماذا تشعر؟ ماذا تقول؟
هل تشعر بالألم؟
أجل، أشعر بالألم. أجل، شكرًا لك. أجل، أقدر لك قلقك عليّ. فعلًا.
ولكن، الآن دعنا لا نتكلّم عن الموضوع، لأني لا زلت لا أملك الكلمات.

II.
ستّة وأربعون يومًا مرّوا على الانفجار في بيروت، وقد غادرت عيادة الطبيب بعد أن نزع لي الجبيرة. قد يستغرق الأمر أربعين يومًا إضافيًا لكي أتخلّص من العكازات، لكن ذلك غير مهمّ اليوم. المهمّ أنّ جرحي تعافى أخيرًا والشمس أشرقت وأشعر بارتياح كبير.
ستّة وأربعون يومًا مرّوا على الانفجار في بيروت، وقد غادرت عيادة الطبيب بعد أن نزع لي الجبيرة.
بعد بضعة أيام، عندما شعرت بقليل من الاطمئنان حيال الخروج من المنزل ورؤية العالم من جديد، أدركت أنّ العكازات تعطي العالم إذنا مسبقًا لطرح سؤال كبير آخر:
– ” شو صار معك؟” (ما الذي أصابك)
– ” الانفجار”
” أوف…” يجيبون والدهشة ترتسم على وجوههم وكأنهم لا يصدقون ليمتلئ الجوّ تلقائيا بأسئلة استيضاحية. وفي بعض الأحيان يبدأ الاستنطاق: ” بس شو صار ؟” (ولكن ما الذي حدث؟).
وهكذا، أبدأ بسرد قصتي مرّةً أخرى من جديد. لديّ صيغات مختلفة لهذه القصّة، واختيار الصيغة المناسبة يعتمد إلى حدّ كبير على اصطفاف معيّن للكواكب في السماء وفي رأسي أيضًا. لكنّ النسخة الكاملة غالبًا ما تبدأ على الشكل التالي:
كنت وحدي في البيت واقفًا وسط غرفة الجلوس أتفقّد هاتفي منتظرًا وصول وكيل العقارات عند الساعة السادسة مساءً برفقة زبون أبدى اهتمامه بشقتي التي عرضت للبيع.
عند الساعة ستّة وسبع دقائق، لم يكونا قد وصلا بعد. وإذ، من حيث لا أدري، يجتاحني دوّي قويّ للغاية ويُغرق المدينة في صمتٍ عميقٍ لما بدا لي كبرهة وجيزة.
في هذه البرهة الوجيزة، وقعت الأحداث جميعها في نفس الوقت تقريبا.
في هذه البرهة الوجيزة، وقعت الأحداث جميعها في نفس الوقت تقريبًا: نظرت من نافذتي لتأخذني ذاكرتي إلى عام 2005 حين كانت سلسلة التفجيرات تطارد أرواح السياسيين والصحفيين في كلّ مكان، واحدا تلو الآخر، لمدّة عامٍ كاملٍ.
وقبل أن تغمر موجة الحزن جسدي.. – بوووم – يأتي الانفجار الثاني مدويًّا بشكلٍ عنيفٍ للغاية. شعرت بموجة كهرومغناطيسية تخترقني. الزجاج تحطّم أمامي وملأ الصراخ الشارع. نظرت إلى نفسي لأكتشف ما يشبه الحفرة في قدمي اليسرى والدم يتطاير في كل مكان. دفعتني غرائزي إلى مغادرة المنزل فورًا والتوجّه إلى أقرب مستشفى. أخذت منشفة ولففتها على جرحي محاولًا إيقاف النزيف، ثم أخذت محفظتي والمفاتيح وهرعت إلى الخارج لأكتشف أن المصعد لا يعمل.
من ثمّ أكمل روايتي وأحكي كيف وصلت إلى المستشفى.
أحكي كيف اضطررت إلى نزول أدراج خمسة طوابق على قدم واحدة، ممسكًا بحافة الدرج بيد وبالمنشفة حول إصابتي باليد الأخرى. أحكي كيف بدأت أفقد بصري وصوتي قبل وصولي إلى الطابق الأرضي. أحكي كيف صليت أن تحصل معجزة وكيف استجيبت صلواتي. فجارتي الحامل، فاطمة كانت أول من رآني عند مدخل المبنى وصرخت مرتعبة عند رؤيتي. سمعها الناس في الشارع، فهرع والدها أبو بلال من حيث لا أدري بقطعة قماش بيضاء يلف بها إصابتي. أذكر الناس الكثر الذين رأيتهم بطرف عيني يهرعون لمساعدتي. حملوني فشعرت أنّي ريشة لا وزن لها، ثمّ وضعوني في المقعد الخلفي لسيارة حمراء صغيرة. إنها سيارة أحمد زوج فاطمة الذي شغل المحرك وأخذني إلى مستشفى الجامعة الأميركية الكائن على بعد دقائق معدودة. في السيارة، كانت فاطمة معي في المقعد الخلفي تمسك قدمي وتضغط على الإصابة بالقماش الأبيض والدموع تنهمر على خدّيها. أبو بلال في المقعد الأمامي يشتم كل شيء ولا شيء. أحمد يقود سيارته بعكس السير بأقصى سرعة على حطام الزجاج في الطرقات، وأنا مستلقٍ على ظهري لا أرى سوى الرعب مرتسما على وجوههم.
أحكي كيف صليت أن تحصل معجزة وكيف استجيبت صلواتي.
أتحدث عن وصولي إلى المستشفى التي شرّعت أبوابها للمصابين وعن الأطباء الذين كانوا يركضون في كلّ مكان. أُخبرهم كيف مزقوا ملابسي الملطخة بالدماء وقطّبوا جروحي وضمدوني. كلّ ذلك وفاطمة لم تبارح مكانها جنبي طوال الوقت، رغم الضوضاء والفوضى من حولنا. أخبرهم كيف اكتشف الأطباء في وقت متأخر من الليل أنّ النزيف في قدمي لم يتوقف فتمّ نقلي إلى غرفة العمليات وأجرى لي ثلاثة أطباء عملية جراحية دامت خمسة عشر دقيقة دون إعطائي أي مخدر. أشرح أنّه لم يكن هناك وقت للتخدير. الوقت كان لإنقاذ الأرواح – لإنقاذ حياتي وحياة الناس القابعين على أسرتهم بجانبي.
في النهاية، أتحدث عن أبرز الأحداث التي حصلت معي وأحاول شرح شعوري بالولادة من جديد بعد خروجي من المستشفى بعد أسبوع.
وفي جميع رواياتي للقصّة نفسها، أجد أنّه من الأسهل سرد الوقائع عوضًا عن وصف المشاعر. مع العلم أنّه لا يمكن الإطالة جدا بالحديث، فأنا مقتنع بضرورة مشاركة هذه القصة لأنها تمثّل قصصًا أخرى أيضًا. إنّها قصة ما حدث لنا في الرابع من آب. هي قصة لا يمكن طمسها. لأن الكلمة تبقى أقوى سلاح، لأنّ إيصال الصوت هو عمل سياسي بامتياز، ولأننا نجد بين أسطر قصتنا هذه بريق أمل بالتعافي ذات يوم.
فأنا مقتنع بضرورة مشاركة هذه القصة لأنها تمثّل قصصًا أخرى أيضًا.

III.
لقد قضيت الأشهر الثلاثة الماضية في شمال لبنان بعيدًا عن بيروت كي أتعافى، في مسقط رأسي محاطًا بعائلتي. خلال هذا الوقت، كنت أنظر من نافذتي إلى الحديقة وأتأمل الأرض الشاسعة التي تمتد من خلفها وأشهد ببطء كلّ يوم على تحوّلات الطبيعة وتغيّر الفصول.
لقد أتيت من مكان يرث فيه الناس أشجار الزيتون من أسلافهم، حيث الحياة تتمحور بمعظمها حول المحافظة على هذا الإرث. نعتني بالأرض ونهتم بالأشجار وننتظر موسم الزيتون في كلّ عام. لكن في السنوات السبع الماضية، ضرب الجفاف موسم القطاف. أصيبت أوراق الشجر بفيروس تسبّب بسقوطها قبل أوانها. بما أنّ الأوراق تحمي الثمر، تسبّب الفيروس بموت المحاصيل. بحسب البعض، يعود ذلك إلى الغبار المنبعث من مصانع الاسمنت المجاورة الذي يتساقط على الأشجار ويمنعها من التنفس، علمًا أنّ هذه النظرية ليست دقيقة تمامًا. لكن هذا العام، تمكنت الأشجار من التجذّر في أرضها وأثمرت.
.خلال هذا الوقت، كنت أنظر من نافذتي إلى الحديقة وأتأمل الأرض الشاسعة التي تمتد من خلفها وأشهد ببطء كلّ يوم على تحوّلات الطبيعة وتغيّر الفصول
مع حلول شهر أيلول، كسر النسيم حرارة شهر آب، وبدأ الناس بالترقّب. وصلت أولى زخات المطر التي طال انتظارها في شهر تشرين الأول. يقال أنّ المطر يبارك المحاصيل، فينتظر الناس هطوله قبل أن يهمّوا بالقطاف. أتت الشتوة الأولى في اليوم الذي أنهيت فيه علاجي الفيزيائي واستبدلت العكازات بعصا خشبية كان ابن عم والدي الأكبر سنًّآ قد أهداه إياها. في الأيام التالية، عندما أشرقت الشمس وجفّت الأرض بدأت ألملم نفسي مجددًا. فقد بدأت التحضيرات لموسم الزيتون. استعديت لموسم القطاف متسلحًا بعصاي الجديدة، وقلبي يملؤه امتنان لما سأرثه في أحد الأيام.
أجد أنّه من المفارقة أنّ الانفجار الذي جعلني أفقد الصلة بأرضي دفعني أخيرًا إلى إدراك مدى ارتباطي العضوي بها. عندما يسألني الناس عما إذا كنت أفضّل البقاء أو الهجرة، أجد نفسي أمام مفارقة جديدة. لطالما كرهت هذا السؤال الذي يحدّني بثنائيته الحصرية ولا يترك أي مساحة لأي حلّ وسطي. لكني لا أعلم إن كنت سأبقى أو أهاجر. ما أعرفه الآن هو أنني متجذّر في هذه الأرض ومتعلّق للأبد بقصة ماضيها. لقد علمتني رحلة التعافي أن أتقبل هذا الماضي دون أن أُثقل به. في الواقع، هذا الماضي أغنى حياتي وأعطى قصتي معنى لا يكتمل من دونه.
أجد أنّه من المفارقة أنّ الانفجار الذي جعلني أفقد الصلة بأرضي دفعني أخيرًا إلى إدراك مدى ارتباطي العضوي بها.
عملية الشفاء تتمثّل بالعودة إلى الاكتمال. في خلالها، تتحول الكلمات إلى قوّة تغييريّة. ما أفكر فيه وما أتحدث عنه مهمّ. تلعب طريقة تعبيري عن تجربتي دورًا محوريًا في هذه العملية. يأتي الألم ثم يذهب، لكنه لا يذهب دون أن يقول كلمته. إنّ الجلوس مع الألم يعني الاستماع إليه والتعامل معه. لذلك يشكل الشفاء عملية إبداعية قبل كل شيء. وكجميع الأعمال الإبداعية التي تتحول إلى طاقة تحويلية، ما يبدو على وشك الانهيار غالبا ما ينتهي بالارتقاء.
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تذكرت كثيرًا ما قالته لي صديقة ذات مرة بعد تعرضها لإصابة في المعصم: “العظام استعارة للقلب”. فهي تنشقّ كي يدخلها النور. نعم، فالضوء يتحوّل، والتمثيل الضوئي أكبر مثال على ذلك. نعم، لقد كنت ضحية عنف لا يمكن تصوّره. لكن النور يدخل تدريجيًا حين أتبنى قصتي دون أن أكون الضحية فيها.
“العظام استعارة للقلب”. فهي تنشقّ كي يدخلها النور.
ربما ليست صدفة أن تزهر الأشجار بعد سبع سنوات. لطالما سحرتني الألغاز التي تكمن في هذا الرقم السحري. فهناك سبعة ألوان في قوس القزح، وسبعة أيام في الأسبوع، وسبعة مراكز طاقة (شاكرا) في الجسم، سبع نوتات في الموسيقى وسبع عجائب في الدنيا… في الشعر العربي، تكتمل القصيدة بالبيت السابع. الرقم سبعة يشكل ارتقاءً بحدّ ذاته.
في السنوات السبع الماضية، ذهلت بوالدي الذي لم يفقد الأمل في الأرض. استمر بالعودة إليها محاولًا…أظن أنّه كان يؤمن في صميم أعماقه بحصول معجزة طبيعية، وأنّ الحياة تعود دائما بطريقة ما. تماما كالشعر الذي يكتمل في البيت السابع، نصل في النهاية إلى حيث يجب أن نكون رغم المصاعب والتحديات. ذلك لأنه في أعماقنا انجذاب مطلق للشمس.
Inner migration was produced as part of the Switch Perspective 2020-2021 project, supported by GIZ. All illustrations by Aude Nasr. Story translated by Sahar Ghoussoub.